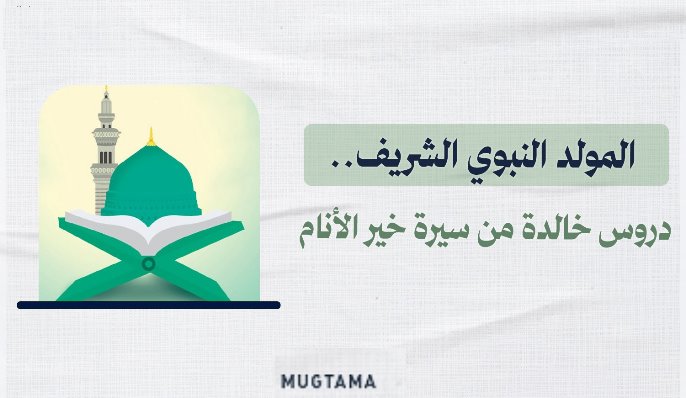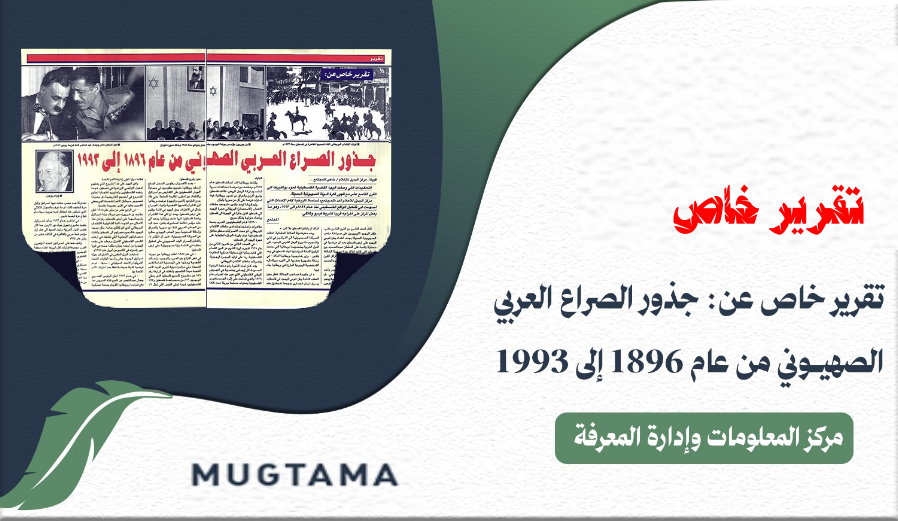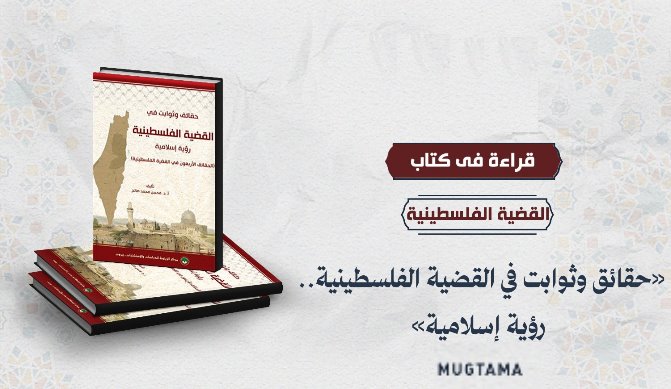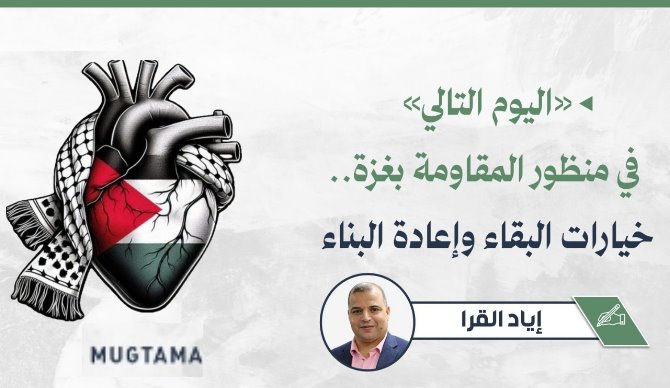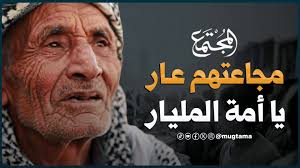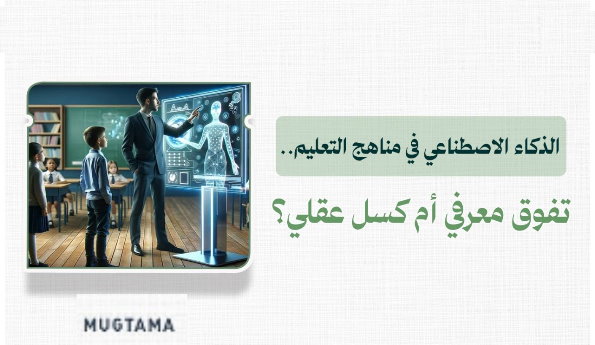عند الثامنة والربع من صباح السادس من أغسطس 1945م، انفجر «ليتل بوي» فوق هيروشيما، كانت المدينة تمشي إلى نهارها العادي حين هبط الضوء الأبيض الخاطفُ ليُسقِط في دقائق عالمًا كاملًا.
في ذلك الصباح قُتِل عشرات الآلاف على الفور، قبل أن ترتفع الحصيلة مع نهاية العام إلى نحو 140 ألف إنسان في هيروشيما وحدها، ثم ما يقارب 70–74 ألفًا في ناغازاكي، وتستمر الآثار الإشعاعية في حصد الأرواح لسنوات تالية.
لم يكن ذلك مجرّد فصلٍ حاسم يُنهي حربًا؛ كان تأسيسًا لعصرٍ تتغيّر فيه القوّة العسكرية بأكملها، وتُعاد كتابة أخلاق الحرب على مقاس المنتصر.
الرابط بين هيروشيما وغزة
بعد 80 عامًا، تقف غزّة كنقطة اختبارٍ قاسية للضمير العالمي، الأرقام وحدها تُقاوم أي تجميل؛ أكثر من 61 ألف قتيل منذ أكتوبر 2023م، وارتفاعٌ متواصل في وفيات سوء التغذية، فيما تحذّر الأمم المتحدة من مجاعةٍ معمّمة، ليس هذا جدلًا لغويًا حول توصيف المأساة، بل وقائعٌ موثّقة تخرج من منصّات أممية يومًا بعد يوم.
لكن الرابط الأخطر بين هيروشيما وغزّة ليس في عدد الضحايا فحسب، بل في الآلية التي تُغسِّل العنف أخلاقيًا، في عام 1945م قُدِّم القصف النووي في الخطاب الأمريكي بوصفه طريقًا سريعًا للسلام يحفظ الأرواح ويُعجِّل بالنهاية.
وبين عامي 2023–2025م يُعاد تدوير معجمٍ مشابه؛ حرب دفاعية، استهداف الإرهاب، أضرار جانبية مؤسفة؛ وباسم هذه المفردات يُستباح المجال المدني ويُختبَر صبر القانون الدولي، إننا إزاء ما يمكن تسميته -تحليليًا- الغسيل الأخلاقي؛ تحويل الإضرار الواسع بالمدنيين إلى ضرورةٍ رحيمة عبر مزيجٍ من الأثر المزدوج والتناسب والطوارئ القصوى، حيث يُسمَح بما لا يُسمَح به بدعوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هذا النمط لم يولد في غزّة، لكنه يظهر فيها الآن مكشوفًا بلا أقنعة، وعلى هذه القاعدة يؤسس نتنياهو دائماً خطابه الأخلاقي بقوله: إن لدى «إسرائيل» الجيش الأكثر أخلاقية في العالم!
في فيتنام أيضًا، سارت ماكينة التبرير على الوتر ذاته؛ حماية العالم الحر ضد الخطر الشيوعي، حتى فجّرت مجزرة «ماي لاي» الوهمَ عن حدود هذا الخطاب، كاشفة قتل مئات المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال، هنا تتبدّل الجغرافيا، ويبقى العنفُ يُسوَّق كشرٍّ لا بدّ منه، ثم يُطوَى في أرشيفٍ رسمي مُصاغ بلغة الواجب والمصلحة العليا.
في غزّة اليوم، الحُجّة المعاصرة تتّخذ شكلين متلازمين؛ ضرورةٌ أمنية تُوسِّع تعريف الأعيان العسكرية حتى تلامس البنية المدنية بأكملها، واستثناء قانوني يمدّ مظلّة الأثر المزدوج بحيث تصبح القاعدةُ ذاتها مرنة إلى حدّ الذوبان، النتيجة العملية واضحة؛ انهيارٌ صحي موثّق بمئات الهجمات على المرافق والإسعاف، وتجويع وصفته الأمم المتحدة أنه من الدرجة الخامسة، وأن جميع سكان القطاع يواجهون أزمة أو أسوأ من الجوع، ما يحدث ليس سوء إدارة للمساعدات الإنسانية؛ إنه تجويعٌ مُمنهج تثبته المؤشرات وتقرع أجراسه المنظمات الأممية.
اختبار أخلاقي.. بين مبادئ العدالة وواقع القوة
على مستوى القانون، لم تعد المسألة أخلاقيةً مجردة، محكمة العدل الدولية أصدرت أوامرَ مؤقتة متتابعة منذ يناير 2024م، ثم في 24 مايو 2024م خصّت رفح بأوامر وقفٍ لأي عملياتٍ قد تُفضي إلى تدمير جماعي وتيسير دخول المساعدات وفتح المعابر، هذا ليس حُكمًا في النية الإجرامية بعد -المحكمة لم تفصل في الجوهر- لكنه تعريفٌ قضائي للأخطار ولِما يجب اتّقاؤه فورًا، ومع ذلك دخل الجيش «الإسرائيلي» رفح ودمرها بالكامل وأخرج منها نحو مليون من أهلها ومن النازحين فيها دون أي اعتبار للقانون الدولي، وفي تجاهل واضح لكل المعايير الإنسانية، ودائماً ما يقدم مبررات أخلاقية على سلوك يُصنف في أبسط أشكاله بأنه استمرار لجريمة إبادة جماعية.
وموازيًا، دخل المسار الجنائي حيّزًا غير مسبوق حين أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر 2024م، مذكّرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، على خلفية اتهامات تشمل التجويع بوصفه وسيلة حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ ثم رفضت الدوائر لاحقًا طلبات سحب هذه المذكرات وبقيت سارية حتى منتصف 2025م على الأقل، مهما يكن موقف العواصم، فإن لغة الاتهام هنا تُسمّي الأشياء بأسمائها وتلتقط جوهر الفعل: تحكّمٌ ممنهج في مقوّمات الحياة المدنية.
هل يعني ذلك أن هيروشيما وغزّة حالةٌ واحدة؟ قطعًا لا، السياقات مختلفة، لكن البنية التبريرية واحدة: تسويق القصف والحصار كضرورةٍ رحيمة، في الأولى، خُتِمت الحرب برسالة قُدّمت أخلاقيًا، وفي الثانية يُدار نزاعٌ طويل بنمط الاستثناء الدائم حيث تُعلَّق القواعد باسم القواعد ذاتها، وبينهما تاريخٌ كامل من صوغ الضرورة في صورٍ متعددة، من قصف مدنٍ كاملة باسم التكلفة الأقل على المدى الطويل، إلى هندسة التمييز بحيث يُعاد تعريف المدني كلّ يوم.
ما الذي يعنيه هذا للنظام الدولي الذي قيل: إنّه وُلد بعد عام 1945م كي لا تتكرر مأساة هيروشيما وناغازاكي؟ المعنى البسيط الصادم؛ المنظومة الدولية قادرةٌ على كتابة قيمٍ رائعة لكنها أقل قدرةً على إنفاذها حين تصطدم بالقوّة العارية، هنا، تتكشّف المفارقة؛ تُشيد المؤسساتُ خطوطًا حمراء (حظر التجويع، حماية المرافق الصحية)، ثم تُترك دون أدوات إنفاذ فعّالة، فيتضخّم الاستثناء حتى يغدو هو القاعدة، وما لم تُغلَق ثغرات الغسيل الأخلاقي بتحديدٍ أشدّ لمعيار الأثر المزدوج، وبرفع عتبة الدليل قبل استهداف الأعيان ثنائية الاستخدام، وبربط الدعم العسكري بشهادات امتثالٍ إنساني قابلة للتحقّق، فسنظلّ نحمل نظامًا يُبرّر ما وُجِد أصلًا ليمنعه.
ويبقى السؤال هنا مفتوحاً: هل بُني النظام الدولي على نصرٍ أخلاقي، أم على جريمةٍ مُؤسِّسة مُغلَّفةٍ بخطاب الانتصار؟ ربما يكون الجواب الأصدق أقل شاعريةً وأكثر قسوة: لقد بُني على صراعٍ دائمٍ بين القيم والقوّة، ولا يُرجِّح كفّة القيم إلا قدرةٌ مؤسسية على المحاسبة حين تتكلّم الوقائعُ لا البلاغة، وحين نصل لقناعة بأن العالم أكبر من 5 دول، وأننا من هيروشيما إلى غزّة، لا نزال في امتحان أخلاقي مفتوح حول قيمنا ومبادئنا الإنسانية.
أدهم أبو سلمية