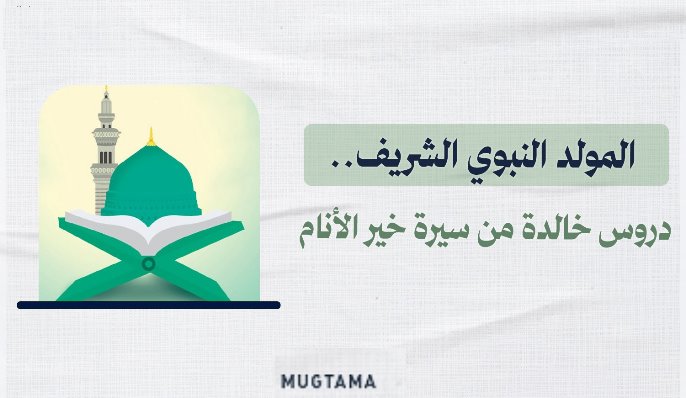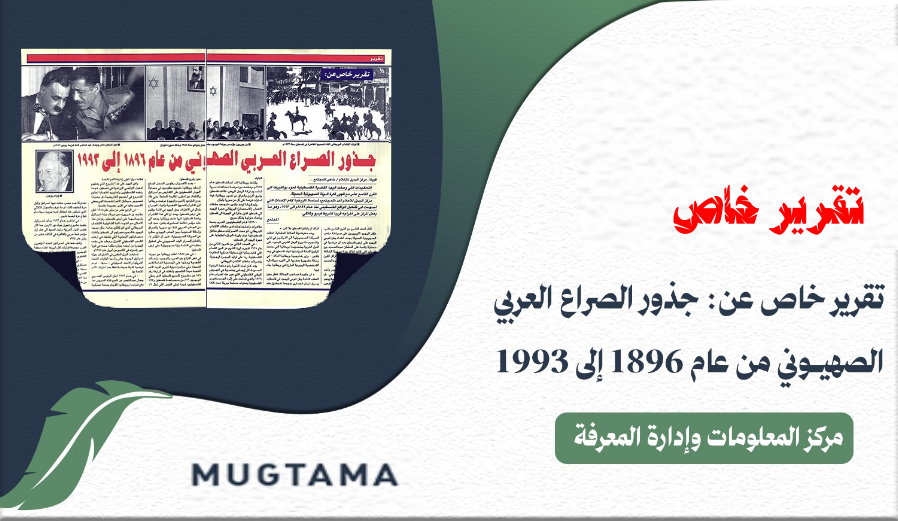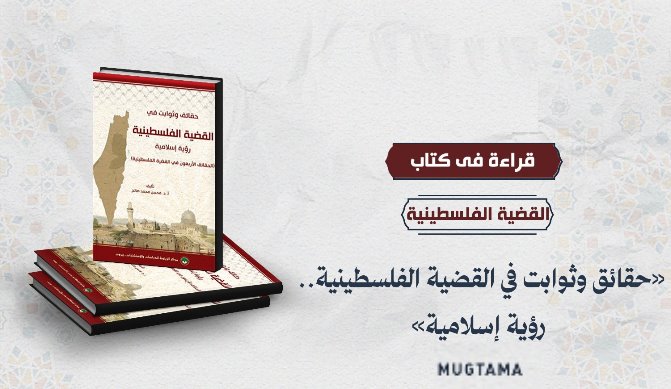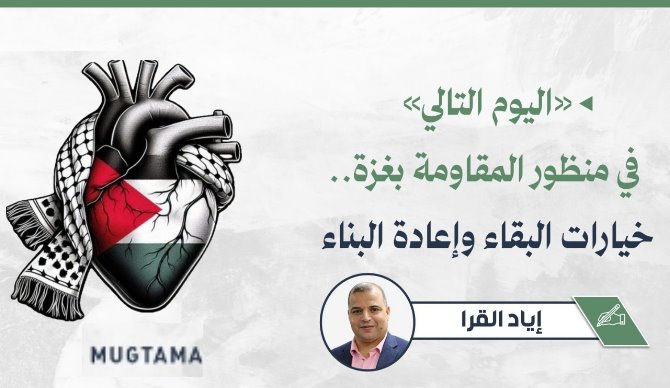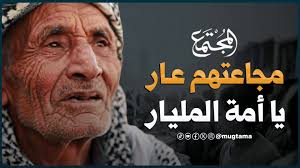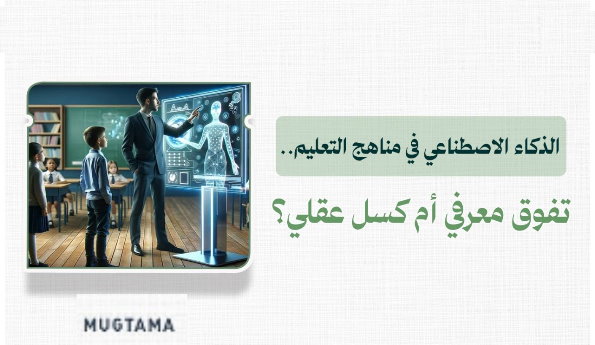يطرح القرآن الكريم مفهوم «الفهم» بوصفه عملية شاملة تُنتج الوعي والرشد، وتمكّن الإنسان من إدراك ذاته وعلاقته بالكون، والتمييز بين الخير والشر، والحق والباطل، ولا يقف «الفهم» في المنظور القرآني عند حدود الإدراك الحسي أو الذهني، بل يتعدى ذلك ليصبح طريقًا إلى الإيمان وسبيلًا إلى التزكية، فهو مشروع شامل، تتكامل فيه الحواس والعقل والقلب مع الدراسة والبحث وتحري الحقائق، لتصنع إنسانًا كيسًا فطنًا، مؤمنًا بربه، واعيًا بمكانته، متفاعلًا مع الوجود بحكمة وإيجابية.
ورغم أن كلمة «الفهم» ومشتقاتها لم ترد صراحة في القرآن الكريم، فإن مترادفات شتى قد عبرت عن الحرص القرآني على تحقق الفهم للمؤمنين، عبر عدد من الأطر الأساسية التي رسمها الوحي لتكوين الفهم، وتبيان لكيفية تفعيل هذه الأطر في الواقع، لننتقل من المعرفة السطحية إلى الإدراك العميق الذي يحوّل الفكرة إلى وعي، والوعي إلى عمل مؤثر يسترشد بالوحي لتحقيق مراد الله من الإنسان وتعمير الأرض لا إفسادها أو تدميرها.
الفهم والإيمان
ربط التصور القرآني ربطاً قوياً متبادلاً بين الفهم والإيمان، فالفهم الحقيقي يتكئ على قلب مؤمن نقي، بينما يتحقق الإيمان عبر انفتاح العقل على الفهم والفقه والتدبر الواعي، وهو ما أكده القرآن في غير موضع حين وجه النقد إلى الكفار الذين فضلوا التقليد الأعمى للسابقين على الفهم والتدبر في الدعوة الإسلامية، وهو ما دفع أيضاً إلى الربط بين الكفر ومفاهيم مثل الضلال والجهل.
وفي النهج الصوفي الإشراقي، فإن تمام المعرفة الحقة والإشراق الرباني على العبد بالفهم والوصول إلى الحكمة الإلهية ومراد الله لا يتأتى من دون تعبد وإيمان حقيقي وطاعة مطلقة للأوامر الربانية، وقد أشار إلى ذلك ابن عربي في التدبيرات الإلهية قائلاً: إن العلم نتيجة التقوى، أما إخوان الصفاء فقد أوردوا في موسوعتهم تدليلاً على الربط بين الإيمان والفهم؛ بأن موسى عليه السلام قد مكث أربعين يوماً صام نهارها وقام ليلها ففتح الله عليه بتنزيل الألواح.
ومن ناحية ثانية، فالفهم فريضة إسلامية على المؤمن يمارسها كنهج حياتي متأصل في كافة شؤونه، عبر الانفتاح العقلي والقلبي على آيات الله المحيطة بنا في الكون: (وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) (يوسف: 105)، وتفعيل العقل والقلب والحواس لتلقي الفهم عن الله عبر اتباع الأوامر القرآنية بالتدبر والتأمل والتعقل والتفقه الدائم والمستمر.
أبواب الفهم الأربعة
ولكي يتحقق الفهم، فإن هناك أبواباً يجب على المؤمن أن يبقيها دائماً منفتحة استعداداً للوصول إلى المعرفة الحقة، وتلك الأبواب أربعة: العقل، والقلب، والحواس، والبحث والدراسة، وهي الأبواب التي ذكرها القرآن الكريم في غير موضع لأهميتها في تحقق عملية الفهم المنشودة:
1- القلب: ويرتبط بالإيمان والاتزان النفسي الذي يسمح بالانفتاح والتمحيص، وبدون هذا القلب الواعي الرقيق اللين لن يصل الإنسان إلى الحقيقة التي تتطلب مرونة نفسية واستعداداً للتخلي عن المعتقدات الخاطئة، وعلى العكس تورث غلظة القلب وقسوته عجزاً عن الفهم؛ (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) (البقرة: 74).
وعن دور القلب في تعطيل الفهم يقول القرآن: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج: 46)، وفي موضع آخر: (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) (ق: 37)؛ أي أن فساد القلب يؤدي إلى العجز عن الفهم حتى وإن كان العقل والحواس سالمين.
2- العقل: والعقل هو مكمن التفكر والتدبر الذي به يتمكن الإنسان من التحليل والإدراك ليتوصل إلى النتائج السليمة التي تقرب من الحق وتُبعد عن الباطل، وقد ورد سؤال «أفلا تعقلون؟!» 14 مرة في القرآن الكريم استنكاراً لتعطيل البشر لاستخدام عقولهم التي وهبهم إياها الله لاستخدامها في تحري الحقيقة وفهم سنن الكون.
3- الحواس: ويتلقى الإنسان الحقائق والمعلومات عبر بوابة الحواس قبل أن ينقلها إلى عقله كي يجري عملية التحليل والفهم، والحواس رغم أن كثيراً من الفلاسفة قد حذروا من كونها بوابات غير موضوعية ومخادعة لنقل الحقائق فإنها بالتكامل مع العقل تحقق الفهم الواعي.
وفي القرآن الكريم قد وردت حاستا السمع والبصر كوسيلتين رئيستين لتحقق الفهم للإنسان، ومن ثم فإنهما مجال للمسؤولية الإنسانية أمام الله: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء: 36)، وفي آية شديدة الدلالة، يقول الله تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا) (الأعراف: 179)، هذا التصوير البليغ لا يتحدث عن غياب الأعضاء، بل عن تعطيل وظيفتها في إدراك المعنى، فالقلب لا يفقه، والعين لا تبصر، والأذن لا تسمع؛ لأن الإنسان لم يُفعّل أدوات الفهم التي وُهبت له.
4- الدراسة والبحث: بدأ الوحي الإلهي بأمر شديد الرمزية على أهمية الفهم «اقرأ»، هذه الكلمة التأسيسية لمشروع الإسلام الحضاري تدفع الإنسان إلى البحث والدراسة، فالقراءة ها هنا ليست رفاهية، وإنما فرض إلهي من الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم.
وقد أظهر القرآن أهمية الدراسة والبحث الجاد في الآية: (أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ) (الأنعام: 156)، فلم يعذر القرآن الكفار بحجتهم التي تذرعت بالجهل بالكتب السابقة والدراسات التاريخية للأمم السابقة، وهو ما أحوجنا إليه في يومنا هذا للانكباب على الفهم عبر بوابة البحث والدراسة الجادة، عبر الاعتبار من النهج القرآني الذي خصص خُمس الوحي لرواية سير الأولين، لا للاعتبار فحسب، بل ولفهم سنن الكون، واستيعاب دروس الماضي وإدراك مراد الله من البشر.
وقد تجلت الدعوة الربانية للدراسة والبحث عبر التأكيد على فكرة السير في الأرض لا من باب السياحة أو الانكباب على طلب الرزق فحسب، بل للتفكر في مصائر الأمم السابقة وسنن الله في الكون والخلق: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ) (الروم: 42)، فالسير هنا وسيلة لاكتساب الفهم من التجربة التاريخية والاجتماعية، إذ لا يكتمل وعي الإنسان دون أن يدرك سنن الله في الخلق، وأسباب النهوض والانهيار.
غياب الفهم وأدواته.. أزمة مجتمع
حين تُعطَّل أدوات الفهم في أي مجتمع، يُصبح التفكير جريمة، والتحليل ترفًا، ويُستبدل التلقين بالوعي، والتقليد بالعقل، والتبعية بالاستقلال، وهذه الحالة تُفضي إلى مجتمعات عاجزة عن التقدم؛ لأنها فقدت البوصلة التي تهديها نحو التمييز بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن.
وغياب الفهم لا يعني جهل المعلومات، أو فقر في الإمكانات، بل يعني فشلًا في ربط الحواس بالعقل، والعقل بالقلب، والقلب بالإيمان، وهذا الخلل البنيوي هو ما تعانيه أمتنا اليوم، على الرغم من مثول الدليل القرآني الهادي بين أيادينا نتلقاه بألسنتنا دون إعمال لبوابات الفهم وانفتاح واعٍ على أساليب التفكير ومنهجياته.
وأخيراً، فإن الفهم في القرآن ليس رفاهية فكرية، بل فريضة حضارية، لا تقوم الأمم إلا بها، ولا يُبنى الإيمان إلا عليها، فالفهم سبيل للهداية، وأداة للتمكين، وجسر بين الإنسان وربه، وإن تفعيل الحواس، وإعمال العقل، وتطهير القلب، والانفتاح على الدراسة والبحث مشروع قرآني متكامل لتكوين الإنسان الفاعل في الأرض، المدرك لموقعه في الوجود، والمستعد للمسؤولية والخلافة، ونحن مسؤولون عما عطلناه من النعم الإلهية علينا أمام الله ولن ينفعنا إذ ذاك أن نقول: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ) (الزخرف: 22).
د. مي سمير