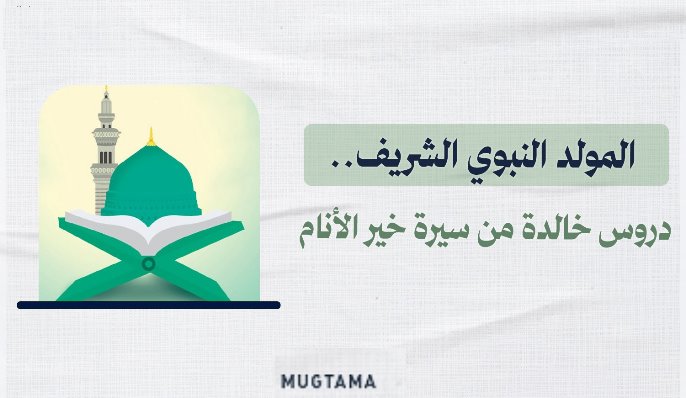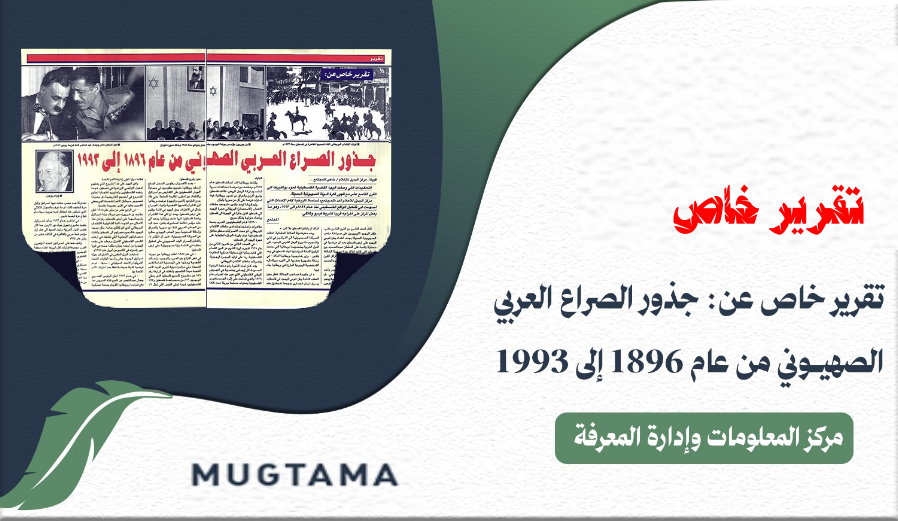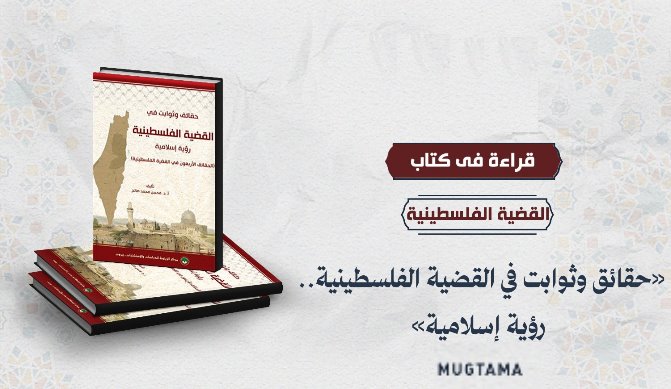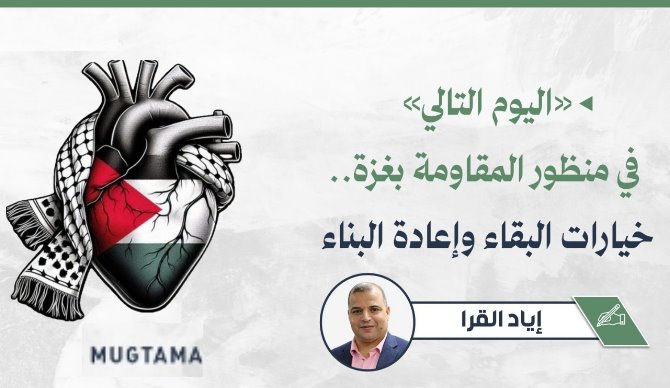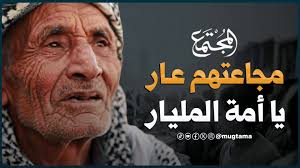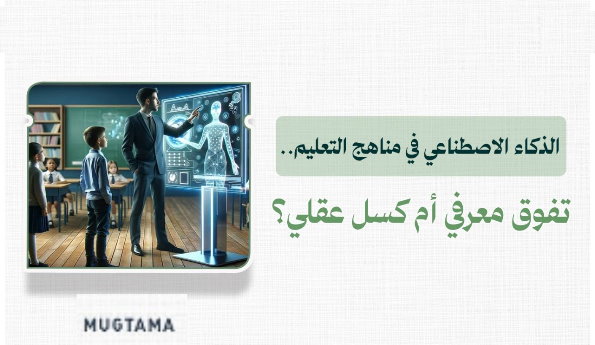مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاماً يدعو إلى الإسلام، تعرض فيها وأصحابه لكل أنواع التعذيب والتنكيل على النحو الذي امتلأت به صفحات التاريخ وكتب السيرة؛ حتى صرخ خباب بن الأرت متألماً وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متشكياً: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟! حيث إن دعوة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم لهي كفيلة بدفع الأذى وكف البلاء.
فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال كلمات حفظها التاريخ ووعتها الأفهام: «لقد كان يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويفرق بالمنشار من رأسه إلى قدمه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظامه، ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه».
كانت آيات القرآن تحث على الصبر وتبين حكمة الابتلاء: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) (العنكبوت: 2)، (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ) (النحل: 127).
ثم جاءت الهجرة بمراحلها الثلاث؛ هجرتين إلى الحبشة، وهجرة إلى المدينة المنورة.
لم تكن الهجرة مجرد انتقال مكاني من بلد الخوف إلى بلد الأمان، وإنما كانت كذلك إعلاناً تاماً بالتخلي عن كل الروابط والعلائق والأخلاق والصفات الجاهلية، وتكوين مجتمع جديد على أسس مختلفة لا بد منها للتمكين في الأرض وإصلاح المجتمعات.
كانت الهجرة انتقالاً من الولاء للقبيلة والعشيرة إلى الولاء لله ولرسوله؛ (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (الأحزاب: 36)، صحيح بقيت أسماء القبائل والعائلات فبقيت قريش وبقي بنو هاشم وبنو عدي وبنو تميم ولكن ظهرت أنماط أعلى من الولاء؛ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات: 10)، ومصطلحات جديدة في القرابة؛ حيث ظهرت مصطلحات «المهاجرون»، و«الأنصار«، و«أهل بدر»، و«أصحاب بيعة الرضوان».
وكانت الهجرة تخلصاً من كل ما يشد الإنسان إلى الأرض إلى أفق جديد يرنو المسلم بعينيه إلى الجنة، ويهتف وهو يلاقي الموت: فزت ورب الكعبة، أليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات.
كانت الهجرة انتقالاً من أخلاق الجاهلية إلى أخلاق الإسلام، كانت انتقالاً من الظلم والعدوان إلى العدل والرحمة، ومن الشح والبخل إلى العطاء والإيثار، ومن الفخر والكبر إلى التواضع والإخبات؛ (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (الحشر: 9)، (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ) (الفتح: 29).
كانت الهجرة تخلياً عن كل الأعراض والأغراض، وتسليماً لله ورسوله، وإعلاناً بالتخلي عن كل شيء في سبيل الله؛ نصرة لله ورسوله: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (التوبة: 24).
كانت الهجرة هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله محبة وطاعة وإيثاراً ونصرة وجهاداً ودعوة، وهي كلها أخلاق لا بد منها للتمكين ولإقامة المشروع الحضاري الإسلامي الذي كان الناس يحتاجونه في ذلك الوقت.
د. موسى زايد